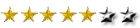سلمى والحجارة
حجارتهم تشج رأسي.. تقتلع كبدي.. تحكُّ في عيني بذور التراخوما القديمة، تلوّحني شلواً في ذراع طفل من غزّة، أو مقلاع يافع من نابلس.. توقظني من إغفاءة السدور التي امتدت أربعة عقود من الزمن.. من الثامنة والأربعين حتى الثامنة والثمانين..
أربعة عقود وأنا قابع كالمقهور.. أقضم الشعارات، واعدُّ جنازات الشهداء، وسلمى تمد رقبتها المعروقة. وبين أصابعها دخينة فاخرة بثمن وجبة الخبز اليومي لأسرة كادحة وهي تقول:
-. صدعت رأسي بحديث السياسة.. " فخّار يكسّر بعضو ".. ويتراكم الفخّار المتكسر في الدروب العربية أكواماً.. تلالاً. جبالاً.. على مدى أربعة عقود.. يسد الطريق والأفق، ويصبح أسواراً بيننا هنا، وبينهم هناك.. بين الأرض المحتلة والأرض المهددة بالإحتلال.. من سد الطبقة إلى سد أسوان.. من الفرات إلى النيل.. من عروش السلاطين على الخليج إلى شواطئ أغادير على المحيط.
فخّار يكسّر بعضه بعضاً.. وسيوف عربية تتقاطع ولا تتلاقى، ومضيفة مكشوفة الركبة تبيع الإبتسامات بالمجان على إرتفاع ثلاثة وثلاثين ألف قدم في الجو " للشقيق " المغادر أو القادم.. وعلى الأرض - في المطارات العربية.. يقف هذا " الشقيق " أمام كوّة (الأجانب ) وتُفتش جيوبه وحقائبه ورموش عينيه.. وسلمى ما تزال تدخن وتمد رقبتها المعروقة وتقول: صدعت رأسي بحديث السياسة.
. . .
أمس.. مرّت الذكرى.. مرت فاترة، بل مقتولة.. ذكرى مرور عشر سنوات كاملة عل استشهاد صبية القضية ورفاقها.. تسألون من هي؟. ومتى حدث ذلك؟ هل يهم الأسم والزمان والمكان..
هي دلال سعيد المغربي.. فتاة من قطر ذبيح أسمه فلسطين، صبيّة طالعة من خيمة النكبة، من خيبة النزوح.. من جراح النكسة.. من خندق الثورة.. شقّت قلب الفجر.. اخترقت جدار الخوف، انطلقت مع رفاقها بروح الحكمة العربية القديمة القائلة: "آخر الطب الكي ". الكي ، بالنار .. وبالبارود، وبالغضب.. وبالمتفجرات.. وبالرفض.. وبالقنابل..
سأعود عشر سنوات إلى الوراء.. إلى آذار العام الثامن والسبعين بعد التسعمائة و الألف ...شبّت دلال و الأرض حولها جراح تنزف، وصراخ لا ينقطع إلا ليرتفع أكثر.. جراح في القلب، والعنق، والخاصرة، وصراخ يتعالى هنا وهناك، ولا ينتهي.. صراخ الجارة فاطمة فوق جسد ولدها المسجى.. صراخ الجنين الذي أجهضت به أمه..والآخر الذي ولد.. والثالث الذي لم يولد.. صراخ الإذاعات العربية.. وصراخ الإغاثة من الإغاثة..
أرادت ان تصرخ بدورها.. شقّت حنجرتها وسحبت منها الصوت، لكنه ظل حشرجة مخنوقة..
وأعوام.. وأعوام...
والجرح يتحول إلى دمّل كبير ينز صديداً وانتظاراً، والصراخ يتحول إلى دويّ يثقب الأذن والشغاف ولبّ العظام
وأعوام.. وأعوام...
وما أزال قابعاً كالمقهور، أقضم الشعارات وأعد جنازات الشهداء وأنا أتساءل:
-.من إذن للمهمّة؟. من للقضّية: هي؟. أنا ؟.. هم؟. أنتم الذين سيأتون؟ هؤلاء الأطفال في الضفة و القطاع والجولان؟. الذين يوجهون اليوم حجارتهم إلى رؤوسنا قبل أن يوجهوها إلى خوذات جنود الإحتلال؟.
قبل دلال ورفاقها، بعشر سنوات أخرى (( هل تعدوّن معي العقود إلى الوراء؟ )) عادت القافلة الأخيرة تعبر النهر مقهورة بعد أن سدت في وجهها الحدود العربية التي تزنّر الأرض المحتلة..
كنت في تلك القافلة.. عبرنا النهر عائدين.. أما الأثقال الأخرى فقد ظلت هناك.. في الأرض المحتلة: الجثث والركام والصور التذكارية التي كانت معلقة على الجدران.. خرجت بجراحي النازفة، وبصورة حفرت في قاع رأسي لمازن وبقية الرفاق، يتهاوون قبلي في بحر الملح، وقد شدَّت رقابهم عنوة إلى حجر الطاحون..
لا تصدقوا كلام الشعراء..
لا تقولوا أن هذه الدماء التي تروي التراب ستورق أشجار الزيتون.. مات الزيتون في أرضنا منذ سنين طويلة.. وأصبح البرتقال - هل جاءكم حديث البيارات - مجرد كتل دائرية في الصناديق المصدرة إلى الغرب، موشومة بشارة العدو بالنجمة السداسية..
كان ذلك يوم العبور.. ولكن في المسار المعاكس.. من الغرب إلى الشرق.. كنت آخر فرسان القافلة التي عبرت.. عدت مقهوراً أقضم الشعارات و أعد جنازات الشهداء في المخيمات المقصوفة، والبيوت المنسوفة. والأراضي المحروقة .
عدت لأجالس سلمى، وانفراج ابتسامتها عن أسنانها التي صبغها الدخان ينقر عيني.. حتى ساقها العبلاء التي بدت من ثوب الحمام ، والتي كثيراً ما اثارت شهوتي وأعصابي ، بدت كساق راقصة متقاعدة.. كانت تداعب شعري وتحاول أن تقنعني بعدم جدوى ما نفعل.. أنا ومازن والرفاق، وكنت أحاول أيامها أن أقنعها بدوري بأننا ما نزال نقفز إلى أعلى في الوقت الذي بدأنا نهوي فيه إلى بئر بعيدة القرار..
سأعترف.. ( هل جاء إعترافي متأخراً )، بأننا نحن الذين أردنا هذه المهمة الصعبة عن اختيار وتصميم.. المهمة التي تعاورتها جيوش العرب، وكتائب الإنقاذ، وسرايا المتطوعة، وخلايا المقاومين.. أردناها مهمة فدائيين يخرجون من الصف إلى المواقع المتقدمة، ولكننا فوجئنا بأننا مطالبون بالكثير ونحن محشورون في قواعد ضيقة، ومحاصرة، بأن نفّتح الأزهار الربيعية على سطح الماء الآسن في بحيرة تمتد عبر الصحارى التي حولنا..
مازن.. كان في موقع القدوة.. منذ سنين بعيدة وهو في هذا الميدان.. منذ أن كنا أطفالاً ينقسم صفنا إلى قسمين: العساكر واللصوص.. كان خير قائد للعساكر، وكم من مرة هزمنا، وكنت بين عساكر فئته - لصوص الحي المجاور
وكبرنا.. وكبرت همومنا..
دخلنا الجامعة وظل مازن في موقع القدوة.. وعندما أصبحنا معلمين، خيّل إلي أنه انتهى واحداً من الذين يبحثون عن الرغيف واقفين أمام السبورة السوداء يستعيدون معلومات محفوظة أمام التلاميذ..
وفي يوم.. قذف مازن السبورة السوداء بقطعة الحوار، وخرج من المدرسة إلى غير رجعة، وخرجت بعده بأيام إلى حيث ذهب، إلى هناك.. كنت دائماً تابعاً لظلّه الشجاع..
تسللنا تحت جنح الظلام.. عبرنا النهر بشجاعة على الرغم من البرد القارص.. وتغلغلنا بين صفوفهم.. أصبحنا تحت جلودهم، فجرّنا أنفسنا قبل أن نفجرّ القنابل.. تراكضوا أمامنا مذعورين في جميع الإتجاهات..
ماذا لو كانت الجراح في صدورنا - نحن أيضاً - التأمت؟. هل تموت القضيّة؟. آه لو تعرف سلمى كم هو مؤلم معنى اليأس في محاولة الإنسان القفز إلى أعلى وهو في حالة سقوط إلى بئر بعيدة القرار..
ماذا لو مات الصراخ في الصدور النحيلة والحناجر المتعبة؟. ماذا لو تركت دلال سعيد المغربي ورفاقها للزورق الذي تسللوا به في فجر ذلك اليوم البارد، مهمة صيد الأسماك فقط، ألايلعننا حتى السمك؟. ألا يلعننا أبناؤنا؟ ألا يستمر الحوت في مطاردتنا حتى يبتلعنا نحن والزورق؟.
ويمضي الزورق.. زورق من نوع جديد، لا كزوارق الصيد، ولا كزوارق خفر السواحل، ولا كيخوت الملوك والأمراء
كان يحمل الغضب.. والقنابل، وكان يحمل امرأة وأحد عشر رجلاً.. رموا همومهم الصغيرة بين مسارب المخيم، وخرجوا في مهمة صعبة، كان عليهم أن يصطادوا الحوت.. أن يشكوا خاصرته بالسهام.. أن يفجروا البارود في كيانه، أن يمنعوه من مطاردتهم.. أن يطاردوه هم بدل أن يطاردهم..
كان الحوت ينتظرهم في كل مكان.. في المياه الإقليمية.. على الساحل.. فوق الطريق الاسفلتيه.. في السيارات العسكرية، في السيارات المدنية.. والأخرى العابرة.. وعلى الحواجز..
وتقدمت دلال.. وتقدم رفاقها.. حققوا عملية اختراق عمودية للشريط الساحلي على طول فلسطين وهم ينشدون لفلسطين.. فحين ركبوا الزورق كانوا قد أعدموا كدسة من برقيات الإحتجاج التي أرسلت عبر ثلاثين سنة إلى الأمم المتحدة وغير المتحدة.. أفّرغوا الحقائب من الأوراق الصفراء اليابسة والتعيسة.. من الخطب والبيانات والقرارات، وملأوها بالقنابل، وبدات عملية حك بذور التراخوما في العيون المقرحة، بحجر النار..
أوقفوا العالم على رجل واحدة.. أعلنوا للدنيا أنهم ليسوا إرهابيين.. بل هم مواطنون من فلسطين، ركبوا زورقاً مطاطياً وعادوا إلى أرض الوطن.. إلى بيوتهم.. إلى بساتينهم، فمنعهم الغرباء وكان عليهم أن يصلوا إلى أرضهم ومنازلهم فاستشهدوا دون ذلك.
هل علينا أن نتذكر أكثر؟. أن نستعيد قصصنا وقصائدنا وحكايات فواجعنا لنغفر أو نستغفر..؟.
" على جدار ذلك البيت الذي تهدم حتى نصفه، كانت هناك صورة ما تزال معلقة، وقد مالت إلى جانب، ولكنها ظلت متشبثة بالجدار.. صورة رجل شيخ، في عينيه غضب، لا أدري لماذا خيّل إلي أن عيني صاحب الصورة كانتا باسمتين قبل أن تنهال تلك القذيفة على الجدار "..
الأثقال الأخرى ظلت هناك.. الجثث، والركام، والصور التذكارية القديمة التي كانت معلقة على جدران البيوت ، وبقيت زهور قليلة طافية على الوجه الآسن للبحيرة الصحراوية العربية الوسيعة..
هل هي أولئك الصغار الذين حمّلناهم هم المواجهة ودعمناهم بالقصائد والأناشيد والتصريحات؟.
أطفال الحجارة.. أبطال الحجارة.. وآلاف العناوين الأخرى عناوين قصائد، وقصص، ومقالات، وتصريحات، وافتتاحيات وكلام.. وكلام...
وما تزال الصحف تتحدث، وما تزال القصائد تعلن عن المنابر، وما تزال الخطب تهز الأثير، وتملأ شاشات الرائي، تسبقها رقصة ويعقبها نشيد، وما تزال سلمى تمد رقبتها المعروقة وبين أسنانها دخينة فاخرة بثمن وجبة الخبز اليومي لأسرة كادحة، وهي تقول: " صدعت رأسي بحديث السياسة، فخّار يكسّر بعضو ".




 الدوايمة(د .. دم)(و..وطني)( أ .. أوثقه)(ي.. يأبى)(م .. مسح )(هـ .. هويته) (دم وطني أوثقه يأبى مسح هويته)...نضال هدب
الدوايمة(د .. دم)(و..وطني)( أ .. أوثقه)(ي.. يأبى)(م .. مسح )(هـ .. هويته) (دم وطني أوثقه يأبى مسح هويته)...نضال هدب
















 الأحد يوليو 30, 2023 3:30 pm من طرف
الأحد يوليو 30, 2023 3:30 pm من طرف